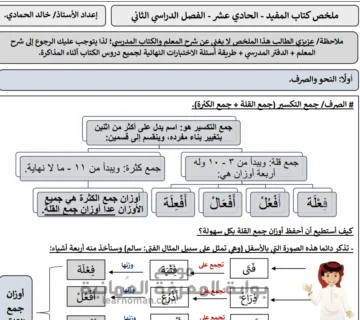النص الإثرائي “عبد الرحمن شكري بين ثقافتين” وتحديدًا فقرة تتحدث عن حياته. الصف الحادي عشر الفصل الثاني
نص إثرائي: عبد الرحمن شكري بين ثقافتين
حياته:
في أسرة مغربية الأصل، وُلِد عبد الرحمن شكري، وكان والده مولعًا بالأدب. وله صلة بعبد الله النديم، أديب الثورة العربية. اهتم به والده اهتمامًا خاصًا، وحرص على تعليمه، خاصة بعد وفاة إخوته الكبار. تخرّج في المدرسة الثانوية سنة 1904م، ثم التحق بدراسة الآداب وتخرّج فيها سنة 1909م، وحرص على دراسة الأدبين العربي والغربي.
وكان أثناء دراسته يكتب في صحيفة الجريدة التي يُحررها لطفي السيد، ويكتب المقالات والأشعار إلى جانب محمد حسين هيكل وطه حسين، وبعض شباب جيله الذين آمنوا بالتجديد وحملوا لواءه.
وفي سنة 1909، نشر أول ديوان له بعنوان “ضوء الفجر”، ثم ذهب في بعثة إلى إنجلترا ليتعمق في دراسة الآداب، وينشر الجزء الثاني من ديوانه بمقدمة للزيات، ويتعافى من مرضه رغم أنه ظل يكتب في الصحف والمجلات حتى وفاته سنة 1958م، وكانت آخر مقالة كتبها سنة 1949م.
شعره:
شعر عبد الرحمن شكري يُعبّر بوضوح عن انتماء ثقافتين: العربية، والغربية (وخاصة الشعر الإنجليزي). وقد اطّلع عليه في مصر أولًا، ثم تمعّن فيه أثناء بعثته إلى إنجلترا، ورأى أن هذا الشعر يسلك طريقًا مختلفًا عن الشعر العربي وأغراضه، فلا مديح ولا هجاء، بل احتفاء بالعاطفة وكل ما يتصل بالحياة والطبيعة من أفكار وأنغام.
هذا التأثير الغربي التقى عنده بما قرأه في الأدب العربي، وخاصة كتاب الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني، وديوان الحماسة لأبي تمام، واطّلع أيضًا على دواوين الشريف الرضي ومهلهل. فوجد فيهما العزل الطبيعي الذي ينبثق من قلب صافٍ، دون حجاب كثيف من طقوس وجناسات وغريب لفظ، كما في الشعر القديم.
وكان دخوله الشعر من هذا الباب، وديوانه الأول “ضوء الفجر”، يصور هذا الاتجاه – انتماء ثقافتين – فكان ثورة فكرية في أوائل القرن العشرين.
الديوان يخلط خلطًا فنيًا ما بين المديح والتجديد، ويفتتحه بإهداء إلى بعض زعماء الإصلاح (الشيخ محمد عبده، مصطفى كامل، وقاسم أمين). لكنه جاء بنوع جديد، يقتصر فيه الشاعر على التفكير في الموت والحياة من زاوية ذاتية، تميل أكثر إلى التأمل من ميلها إلى الخطابة.
إنه شاعر وجداني ذاتي، بالمعنى الغربي للشاعر الغنائي، فالشاعر ينسج نفسه، وليس نسيج الأحداث السياسية والمواقف القومية. ومن أجل ذلك كان أكثر النغم في الديوان نغمًا محزونًا، فيه يأس وشجن، ووراءه هذا الحب للحياة.
الأسئلة التحليلية والتفسيرية:
٢) استبدل الشاعر زمن الحاضر بزمن المستقبل، فما الذي أنجز عن هذا التحول في الزمن؟
٤) “وكم قَلَّبْنَا خِلًا حبيبًا، وكم من قرينٍ بأن عنه قرينْ”
- أ) ما نوع “كم” في البيت السابق؟
- ب) ما دلالة استخدامها في هذا السياق؟
٥) تكرّر لفظ (الحُسن) أربع مرات في القسم الثالث من النص (7–9)، فما الدلالة التي اتخذها في هذه الأبيات؟
٦) في البيت التاسع تشبيه، ما نوعه، وما دوره في بيان صفة (الحُسن) في نظر الشاعر؟
٧) تكرّر القسم الأخير من النص لفظ (الموت) وبداخله مرّات عديدة:
- أ) استخرج من الأبيات ما يجعل على معجم الموت.
- ب) ما دليل كثافته في هذا القسم الأخير من النص؟
٨) تأملت الدهر والتفكير بالموت دلالة على عناصر الحياة في النص، ما دلالة ذلك في إبراز النزعة التشاؤمية في شعر عبد الرحمن شكري؟ استعن بالنص الإثرائي في الإجابة على هذا السؤال.
٩) “إن القصيدة تُكسب حكميّتها من بعض الحكم الواردة فيها”. علّل.
١٠) اذكر بعض مظاهر التجديد في القصيدة بالنظر إلى بنائها وموضوعها.